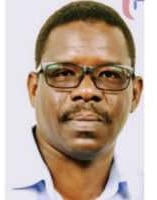محمد بدوي يكتب: ٣٠/ أغسطس
يحتفل العالم في 30 من أغسطس من كل عام باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولعل من الضروري الإشارة إلى الفرق بين المختفين/ات قسرياً وبين المفقودين/ات، حيث تكمن الأهمية في الحالة القانونية، والإطار القانوني الذي يحكم كل حالة، وهو أمر له علاقة بمصير الأشخاص من الفئتين.
عرفت اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2010، وصادق عليها السودان في العام 2021، المختفين/ات قسرياً ب” الإعتقال أوالإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة أو أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمانه من حريتة او إخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون”،أما تعريف الأشخاص المفقودين/ات” هو الشخص الذي لا يعرف اقرباؤه مكان وجدوه، و/أو أبلغ عن فقدانه،إستنادا علة معلومات موثوقة، لاسباب تتصل بحالة نزاع مسلح، اووحالة عنف آخري او كارثة طبيعية، أو اي حالة آخري تتطلب تدخل سلطات الدولة وفقا للتشريعات الوطنية”.
من هذين التعريفين يتضح لنا الفرق، وهذا يقود بالضرورة إلى التعرض للإطار القانوني الوطني السوداني للاختفاء القسري، حيث جاء التعريف في المادة 186 الفقرة ن ” من يقبض على شخص أو اكثر او يختطفه او يحتجزه، بإن الدولة أو منظمة سياسية بعلمها او موافقتها او لسكوتها عليه …. متي كان ذلك لهدف حرمان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التى كفلها القانون” بقراءة نص المادة نجد أن هنالك خللاً ربط الإجراءات بقضاء مدة طويلة، وهذا منفذ لدخول الإجراءات في نفق التطاول وعدم الضبط عبر صعوبة تحديد تعريف أو مدى “المدة الطويلة”.
هذا الخلل النصي يتضح في كون الاختفاء القسري يرتبط بسلسلة انتهاكات مثل: القتل، التعذيب، الخطف، العنف الجنسي وغيرها بالمقابل فإنها حالة لا تقف عند الشخص بل تمتد إلى الأسرة وما يصيبها من جراء ذلك سواء كان نفسياً أو قانونياً، سواء ارتبط بالأحوال الشخصية أو الميراث أو غيره.
تاريخ حالات الاختفاء القسري في السودان ارتبط بفترات النزاعات المسلحة، والفترات التي خضع فيها البلاد لحكم ديكتاتوري، وكذلك في الفترات الانتقالية، ولضيق الحيز لا يمكن التعرض لشمول السجل، لكن هنالك أهمية للإشارة إلى أن حالات الاختفاء القسري في السودان سبقت الاتفاقية الدولية بحوالي 55 عاماً. ففي العام 2000 أصدرت لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان الحالي) قراراً بتشكيل لجنة لمناهضة اختفاء النساء والأطفال في السودان، ولعل الفئة المستهدفة كانت المجموعات التي تعرضت للانتهاكات بما فيها الخطف والعنف الجنسي من سكان جنوب السودان، على أيدي المليشيات التي شكلها الجيش ابتداءً من العام 1984 للمساندة كقوات رديفة في الحرب الأهلية الثانية (1983 – 2005) في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور.
عُرفت اللجنة الوطنية التي تمت بموجب القرار بلجنة سيواك تحت مظلة وزارة العدل آنذاك، وعملت حتى انفصال/استقلال جنوب السودان في 2012، ثم واصلت جهودها حتى 2014 وتمكنت من دمج الآلاف من الأشخاص مع ذويهم. بعد ذلك لم تُبذل جهود وطنية من السلطات إلا في العام 2020 عندما قام النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين، وهي لجنة تكونت عضويتها من ممثلين للنيابة العامة ونقابة المحامين السودانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قادت ظروف متعددة منها تراجع قطاع الطب العدلي بالسودان، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي من انقلاب أكتوبر 2021، ثم حرب 15 أبريل 2023، إلى تعثر جهود اللجنة.
من الجدير بالإشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي هو المعني برصد النزاعات المصنفة تحت القانون الدولي الإنساني مثل حالة السودان في الراهن، بالرغم من أن الحالة في تعقيدها تشمل اختصاصاً آخر تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نشرت اللجنة رقماً للتواصل والتبليغ، وهذه إحدى الوسائل المهمة التي يجدر بذوي المختفين قسرياً اتخاذها لضمان توثيق الحالات المنفذ الثاني هو لجنة عمل الاختفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي مكونة من 10 خبراء، مهمتها تلقي الشكاوى عبر فورم متوفر باللغة العربية أيضاً من ذوي المختفين، وتقوم بدورها بالتواصل مع الجهة التي يقع عليها ادعاء ارتكاب الحالة، وتبذل اللجنة جهوداً كبيرة ومهمة.
في هذا اليوم لابد من الإشارة إلى دور الدولة والامم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى تدريب منفذي القانون ومقدمي الخدمة من الاخصائيين النفسيين والإجتماعين على تقنيات التعامل مع حالات الإختفاء القسري، وتقديم العون والمساعدة لتعزيز التطورات والأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في مناهضة الاختفاء القسري، وهو منحصر في عمليات الرصد والتوثيق ورفع الشكاوى نيابة عن ذوي الضحايا، وكذلك عمليات المناصرة المختلفة. ولعل منظمات ومبادرات عديدة تعمل في هذا السياق، ورغم هذا الدور المتعاظم لها، إلا أن هنالك حوجة للتنسيق بين هذه الأجسام، للمساهمة في تكامل الجهود والمساهمة في إحصائية للمختفيين قسريا ولو تقريبية كنتاج للعمل المشترك.
أخيراً، في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أتمنى أن نرى في المستقبل القريب قانوناً وطنياً سودانياً يحكم الاختفاء القسري، مع تقديم دعوات لوقف الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار الذي يشكل عنصراً مهماً في نجاح عمليات التقصي للمختفين/ات قسرياً.