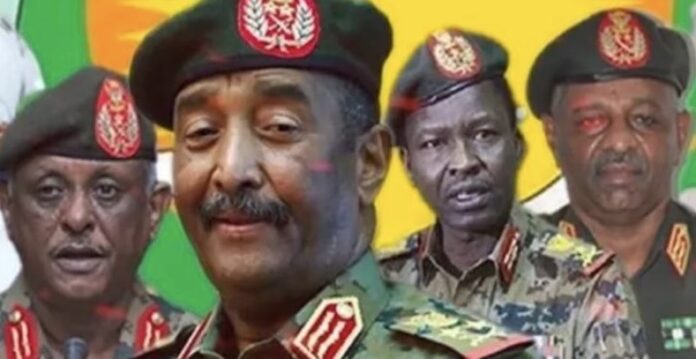عندما تصبح السلطة غنيمة ؟ من يُدير الدولة؟ ومن يملك السلطة والثروة؟(4)
تحليل:حسين سعد
تعتبر المحاصصة السياسية من أبرز الآليات التي ظهرت في البلدان ذات البنية الإجتماعية المعقدة، خاصة في الدول الخارجة من نزاعات أو مراحل إنتقالية، حيث تُعتمد كوسيلة لتوزيع السلطة والثروة بين مكوّنات مجتمعية مختلفة بهدف تحقيق التوازن والإستقرار السياسي، في الحالة السودانية، برزت المحاصصة كأداة رئيسية في إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها، لكنها سرعان ما تحوّلت من آلية (توافق وطني) إلى وسيلة لإعادة إنتاج السلطة على أسس جهوية، قبلية وطائفية، تُغذّيها مصالح ضيقة وتوازنات هشة، لقد لعبت النخب المثقفة – أو من يُفترض أن تكون كذلك – دورًا معقّدًا في هذا السياق، حيث إنقسمت بين من ساهم في ترسيخ هذا النمط كجزء من صفقة سياسية أو نفوذ شخصي، وبين من إلتزم الصمت أو مارس خطابًا نقديًّا لم يرقَ إلى مستوى الفعل السياسي المقاوم، في المقابل، مثّلت الطائفية – بشقيها السياسي والديني – رافعة خطيرة لتكريس ثقافة الولاء دون الكفاءة، وإعادة إنتاج بنية الدولة على أساس إنقسامي يُضعف المؤسسات ، من خلال هذه السلسلة نحاول تحليل العلاقة بين المحاصصة كنظام لتقاسم السلطة والثروة في السودان،؟ وكيف ساهمت النخب والطائفية في تعزيزها بدلًا من تفكيكها ؟، مع محاولة إستكشاف التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا النمط على مستقبل الدولة السودانية.؟
إعادة إنتاج الأزمة:
تُعد المحاصصة السياسية واحدة من السمات البارزة التي طبعت المسار السياسي السوداني منذ عقود، وخصوصًا بعد فترات الإنتقال المتكررة عقب النزاعات والإنقلابات والإنقسامات الحادة في البلاد، فقد تحوّلت المحاصصة من كونها آلية مؤقتة لتقاسم السلطة وضمان تمثيل القوى المختلفة، إلى نمط مستدام من الحكم يعيد إنتاج أوجه التهميش ويكرّس غياب العدالة، وبالرغم من الطموحات الثورية التي طرحتها الحركات الإحتجاجية السودانية، فإن منظومة النخب السياسية، بما في ذلك شريحة من المثقفين، لعبت دورًا في إدامة هذا النهج من خلال الانخراط في شبكات الولاء الطائفي والجهوي، وتبرير ممارسات تعزز منطق التوازنات الهشة بدلًا من بناء دولة المواطنة والمؤسسات، السؤال الرئيسي كيف تحوّلت المحاصصة إلى أداة لإعادة إنتاج النفوذ بدلًا من إعادة توزيع السلطة بشكل عادل، وكيف ساهمت الطائفية السياسية والنخب الثقافية في تقوية هذا المسار، إن تحليل هذا الإشكال يتطلب تفكيك العلاقة المعقدة بين البنى التقليدية والحديثة في السياسة السودانية، ومدى تأثيرها على بناء الدولة وتشكيل الوعي الجماهيري، فبين إستحقاقات العدالة الإنتقالية ومتطلبات الإستقرار، يبقى التحدي الحقيقي في تجاوز المحاصصة كحل سياسي إلى بناء نظام ديمقراطي قائم على الكفاءة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.
أولاً: المحاصصة كآلية لتقاسم السلطة والثروة:
برزت المحاصصة السياسية في السودان كرد فعل على صراعات مسلحة، وحروب أهلية، وتهميش طويل الأمد لأقاليم واسعة مثل دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومع توقيع إتفاقيات السلام، خصوصًا اتفاقية نيفاشا (2005) وإتفاقية جوبا (2020)، أصبحت المحاصصة أداة رئيسية لتوزيع المناصب والموارد بين الحركات المسلحة والقوى السياسية، لكنها في ذات الوقت عمّقت منطق الاستحقاق السياسي مقابل السلاح أو التمثيل الجغرافي بدلًا من منطق المواطنة المتساوية، وتجسدت هذه المحاصصات في توزيع المناصب السيادية والوزارية وفقًا لمعايير إثنية وجهوية، وهو ما جعل الولاء للقبيلة أو الإقليم يتفوق على الكفاءة الوطنية، كما أدى ذلك إلى تركيز الثروة في أيدي نخب محلية أو حركات مسلحة تحوّلت من قوى ثورية إلى شركاء في السلطة، من دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية والتنموية.

ثانيًا: دور النخب المثقفة :
لعبت النخب المثقفة في السودان، منذ الإستقلال وحتى اليوم، دورًا مزدوجًا: فمن جهة، تبنّت خطابات وطنية تنادي بالديمقراطية وبناء الدولة المدنية، ومن جهة أخرى، إنخرط عدد كبير من هذه النخب في التحالفات السياسية التي تستند إلى التوازنات الطائفية والجهوية، إما حفاظًا على مصالحها أو تحت غطاء الواقعية السياسية، وفي كثير من المحطات، ساهم بعض المثقفين في تبرير النظام القائم للمحاصصة، بوصفه السبيل الواقعي لتحقيق السلام أو إدارة التنوع، متجاهلين أن هذه السياسات تؤسس لحالة دائمة من التجزئة السياسية والانقسام المجتمعي، وتُقصي المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى أي نخبة أو طائفة سياسية.
ثالثًا: الطائفية السياسية:
شكّلت الطائفية السياسية – متمثلة في الأحزاب ذات الخلفية الدينية والطائفية مثل حزب الأمة (الأنصار) والحزب الاتحادي (الختمية) – ولاحقاً الحركة الإسلامية عقب إستلامها للسلطة عبر إنقلابها علي الحكومة الديمقراطية شكلت بنية أساسية للسيطرة على القرار السياسي في السودان، هذه الطائفية لم تكن مجرّد ظاهرة إجتماعية، بل أداة فعالة لإدامة السلطة من خلال ولاءات غير سياسية، ما عزز من هشاشة مؤسسات الدولة وضعف الوعي المدني، ومع تكرار التجارب الإنتقالية والإنقلابات العسكرية، أعادت الطائفية إنتاج نفسها بأشكال جديدة، من خلال تحالفات تكتيكية مع العسكر أو الحركات المسلحة، بما في ذلك ما نشهده اليوم من صفقات سياسية تقوم على أساس الجهة والعرق لا على أساس الكفاءة والبرامج
رابعًا: النتائج المترتبة :
تؤدي المحاصصة إلى تسييس الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، مما يقوّض كفاءتها وإستقلاليتها، وإعادة إنتاج التهميش بدلاً من معالجة مظالم الأطراف، تُعيد المحاصصة إنتاج التهميش من خلال تمكين نخب محدودة على حساب القواعد المجتمعية الواسعة، وتفتيت النسيج الوطني، الذي يعمّق منطق المحاصصة، والإنقسامات الإثنية والجهوية، ويغذي الصراعات الأهلية بدلًا من معالجتها، فضلاً عن إنعدام العدالة الإقتصادية، حيث تتحول الثروة الوطنية إلى غنيمة سياسية، تُوزع حسب موازين القوى وليس وفق خطط تنموية عادلة لكل ذلك نري بأن مستقبل السودان مرهون بتجاوز منطق المحاصصة إلى مشروع وطني جامع يعيد تعريف السياسة باعتبارها خدمة عامة لا غنيمة، وهذا يتطلب دورًا نقديًا ومتقدّمًا من النخب المثقفة، لا في تبرير الواقع أو الانخراط فيه، بل في تفكيكه وبناء بدائل تستند إلى دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، والتمثيل العادل ضمن مؤسسات ديمقراطية مستقرة.
الخاتمة:
في عمق المأساة السودانية المتجددة، تبرز معضلة المحاصصة السياسية بوصفها عرضًا لأزمة أعمق في بنية الدولة والمجتمع، أزمة تتجاوز مجرد تقاسم المناصب أو توزيع الثروات إلى أزمة في مفهوم المواطنة ذاته، وفي الكيفية التي يُدار بها التنوع في بلد شديد التعقيد كالسودان، فبدلًا من أن تكون السياسة أداة للتقريب بين المكونات المختلفة، تحوّلت إلى ميدان للابتزاز السياسي والمساومات النفعية، حيث تُختزل قضايا العدالة والتنمية والتمثيل في صيغ حسابية باردة لتقاسم (كيكة السلطة)، تُمنح فيها الحصص لا على أساس الكفاءة أو الالتزام الوطني، بل بحسب مَن يملك السلاح ، إن أخطر ما في المحاصصة أنها لا تُقصي فقط الأفراد الذين لا ينتمون إلى نُخب طائفية أو عسكرية، بل تقصي كذلك فكرة المشروع الوطني ذاته، وقد تحول الوطن إلى جزر معزولة، وتحوّل الإنتماء من الوطن إلى الولاء، ومن المصلحة العامة إلى المصالح الفئوية، وما يزيد الأمر تعقيدًا هو إنخراط جزء كبير من النخبة المثقفة في هذا المسار، إما عبر الصمت، أو التبرير، أو المساهمة المباشرة في هندسة صفقات سياسية تُعيد تدوير نفس الأزمات تحت مسميات (انتقالية) و(توافقية) و(سلام شامل)، بينما الواقع يزداد هشاشة والهوّة بين المواطن البسيط وصاحب القرار تتّسع كل يوم، لكن رغم هذا المشهد القاتم، يظل الأمل ممكنًا في بروز قوى إجتماعية جديدة لا ترى في المحاصصة خلاصًا، بل ترى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الطريق الوحيد نحو سودان عادل ومتوازن؟ الأمل في جيل جديد من المثقفين والسياسيين يتجرأ على نقد البُنى التقليدية، ويعيد تعريف السياسة كأخلاق ومسؤولية لا كحرفة نفوذ وغنائم؟ الأمل في تجاوز وهم (التمثيل بالتوزيع) إلى حقيقة (العدالة بالتنمية)، وفي الإنتقال من تسويات فوقية إلى تعاقد إجتماعي شامل يعيد الإعتبار للمواطن كركيزة أساسية في صناعة القرار؟ في نهاية المطاف، ليس المطلوب أن نرفض التنوع أو نطمس الخصوصيات، بل أن ندير هذا التنوع في إطار دولة عادلة وفاعلة، لا أن نحوله إلى وقود لصراعات لا تنتهي.؟لإن كلفة إستمرار المحاصصة ليست سياسية فقط، بل وجودية؛ فهي تُهدد بفقدان ما تبقّى من لحمة وطنية، ونري إن الخلاص لا يكون بترقيع النظام، بل بإعادة تأسيسه من الجذور، على أساس مبادئ المساواة، والمواطنة، والشفافية، والمحاسبة. وحده هذا الطريق، رغم صعوبته، هو ما يصنع سودانًا يستحق أن يُسمى وطنًا لكل أبنائه، لا دولة حصص ونصيبٍ بين المنتفعين؟( يتبع).