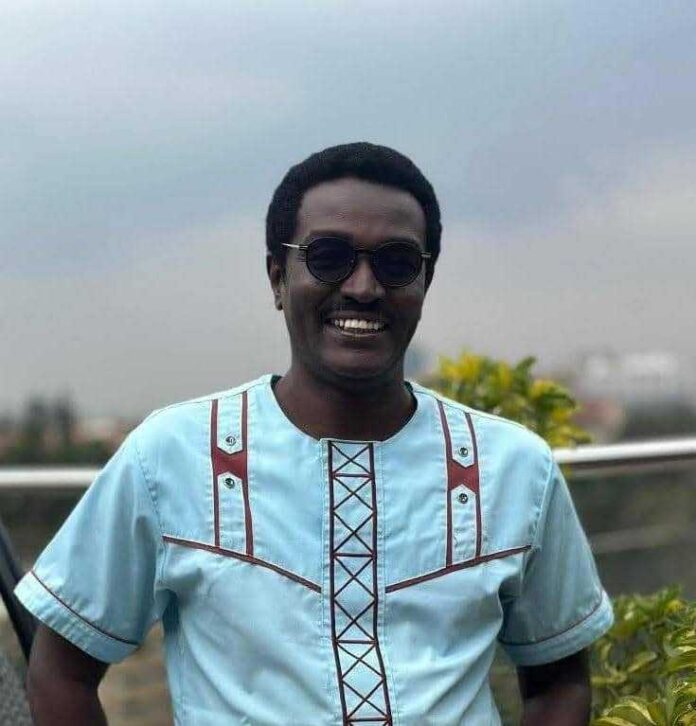كانت الساعة تجاوزت الثامنة والنصف ليلا ً عندما تحرك البص الكبير من محطة شكيلانقو أوفست في دار السلام، متجهاً نحو نيروبي ( عبر بصات كيدية ون )
الهواء رطبٌ ودافئ، والمطر المتقطع يلمع على زجاج النوافذ كحبات لؤلؤ تائهة. في الساحة الخلفية للمحطة، كانت أصوات الباعة تختلط بصفارات البصات، ورائحة الذرة المشوية تمتزج بعطر البن المحمص — رائحة الوداع في المدن الساحلية.
صعد الركاب تباعاً، بعضهم يحمل حقائب صغيرة وأحلاماً كبيرة، وبعضهم يحمل فقط التعب والسكوت جلستُ قرب النافذة، وما إن انطلقت العجلات حتى بدأ الليل يفتح ذراعيه، كأنه يحتضن القادمين إلى عالمٍ آخر، كانت دار السلام تبتعد شيئاً فشيئاً، أضواؤها تنكسر على الأسفلت المبلول كنجومٍ صغيرة تذوب تحت المطر، في الخلف، بدأ أحد الركاب يهمس بدعاء السفر، بينما المذياع يبث أغنية قديمة من تراث تارواب الزنجباري، صوت نسائي شجي يشبه خيوط الدخان المتراقصة في العتمة، على الطريق الساحلي، تتمايل أشجار النخيل مثل راقصات ظلٍّ تحت القمر، والبص يشقّ العتمة بنورين صغيرين أمامه، كعيني حوتٍ فضيٍّ يعوم في ليل المحيط. كل محطة تمرّ بها تحمل اسمًا غريباً كأنّه من أسطورة في كل واحدةٍ منها يتوقف البص قليلاً، يصعد بائع الشاي الساخن، وامرأة تحمل سلال الموز والكاكشي، وطفل يوزّع الزجاجات الباردة بابتسامةٍ لا تعرف التعب، في منتصف الليل، كان الركاب قد غفوا جميعاً تقريباً، إلا السائق ومساعده، يتحدثان بالسواحيلية الخافتة، والليل من حولنا كثيف كحلمٍ طويل. كانت أنوار القرى البعيدة تظهر وتختفي، مثل أنفاسٍ تتردد على وجه الأرض.
قهوة الصباح الساخنة:.
ثم جاءت ساعات الفجر الأولى — تلك اللحظة التي لا تشبه شيئاً في الدنيا. بدأ الضوء يتسلّل من خلف الغيوم، يلامس الغابات والأودية بلطفٍ، كأن الفجر نفسه يعتذر للظلام عن قدومه المفاجئ. رأيتُ في الأفق جبال تلوح كأطيافٍ زرقاء، والضباب ينساب على الطرقات كوشاحٍ أبيض يلفّ الجمال بالحذر، في تلك الساعات الصامتة، كانت أرواح إفريقيا تستيقظ: القرويون يسيرون إلى الحقول، والنساء يحمِلن أواني الماء على رؤوسهن بخفةٍ تدهش العيون، وأصوات الديكة تتقاطع مع نباح الكلاب،
حين توقف البص في احدي المحطات ، خرجتُ أتمشى قليلاً .
كان الهواء بارداً ومنعشاً، تفوح منه رائحة الأرض المبلولة بالمطر، ورائحة البن الطازج من أكشاكٍ صغيرة على جانب الطريق. سمعتُ أحد الباعة ينادي يحمل قهوة الصباح الساخنة ، شربت منها رشفة ، شربتُ منها رشفة، فشعرتُ أن جسدي يستيقظ على نغمةٍ بطيئة من السحر الإفريقي.
مع شروق الشمس، واصل البص طريقه، والضوء ينسكب على التلال الخضراء مثل ذهبٍ سائل، يفتح عيون الركاب واحداً تلو الآخر. كان البعض يتثاءب، وبعضهم يبتسم، وكأن الفجر أعاد إليهم أحلامهم التي سرقها التعب.
عندها أدركتُ أن السفر في إفريقيا لا يقاس بالكيلومترات، بل بالدهشة — دهشة المشاهد المتبدلة، والوجوه المضيئة، والطرق التي تحمل في كل منعطفٍ قصةً جديدة.
الحدود الكينينة التنزانية
كانت الشمس تميل نحو الشروق حين اقترب البص من الحدود بين تنزانيا وكينيا، جاء صوت مضيفة البص باللغة السواحلية تكشف عن الوصول الي الحدود طالبة من الجميع حمل جواز السفر والأمتعة للتفتيش ، الهواء هناك مختلف — يحمل رائحة الغبار والريح القادمة من السهول البعيدة، ممزوجة بعطر الأشجار البرية ودفء الأرض الإفريقية،
توقّف البص عند نقطة الحدود، وخرج الركاب في صفٍّ طويل يحملون جوازاتهم وأوراقهم، بينما يقف ضابط ببدلته الكاكية يرحب بالعابرين بابتسامةٍ فيها هيبة الواجب ولطف الجيرة، وعسكري أخر معه كلب بوليسي لتفتيش الحقائب التي تم رصها وخلفها أصحابها ،في ذلك الصباح الحدودي، كانت الجبال تلوح كأنها حراس قدامى بين بلدين يجمعهما أكثر مما يفرّقهما، النساء التنزانيات بملابسهن الملوّنة كنّ يضحكن ويتبادلن الكلام مع البائعات الكينيات، وكأن الحدود مجرد خيط من الرمل لا يملك أن يمنع دفء الأواصر.
بعد إتمام الإجراءات، تحرّك البص من جديد، يعانق الطريق نحو فوي ، حيث تبدأ الأرض بالانفتاح على أفقٍ عظيمٍ كصفحةٍ من الضوء، كانت السهول تمتد بلا نهاية، تتناثر فيها الأشجار المتفرقة مثل نقاط الحبر على ورقٍ أصفر، وأسراب الظباء تمرّ مسرعة كأنها ومضات من الخيال ، في المقاعد الخلفية، بدأ الركاب يستيقظون على نغمة الحياة الجديدة. أحدهم يفتح هاتفه ليستقبل رسائل أهله، وآخر يلتقط صور السهول من النافذة،
صوت المحرك كان كأنّه إيقاع الطبول الإفريقية، متواصلاً، عميقاً، يرافق الرحلة كنبضٍ لا يهدأ.
مررنا عبر حيث تلتف الطرق بين الهضاب، والبص يتهادى كقاربٍ بريٍّ فوق موجٍ من الغبار.
على جانبي الطريق، تنتصب الأكواخ الطينية، وتتناثر عربات الشاي والذرة المشوية، والنساء يرفعن أيديهن مودّعات.
كانت الأرض تزداد جفافاً كلما اقتربنا من الشمال، لكنّ السماء كانت تمتلئ ضوءاً ووعوداً.
مع كل كيلومتر نقترب فيه من نيروبي، كان المشهد يتبدّل: من السهول المفتوحة إلى المرتفعات الخصبة التي تعانقها المزارع الخضراء، حيث الأبقار البيضاء ترعى في هدوءٍ، والمزارعون يسيرون بين الحقول بابتساماتٍ مطمئنة.
وفي الساعه الحادية عشر صباحاً ظهرت نيروبي — مدينةٌ لا تأتيك دفعةً واحدة، بل تتسلّل إلى عينيك شيئاً فشيئاً.
ثم، فجأة، انفتحت المدينة أمامنا مثل قصيدةٍ طويلةٍ من الأضواء. من أعلى الطريق، بدت الأبراج تلمع تحت غيمٍ رمادي، فيما تتصاعد أنفاس المدينة كدخانٍ خفيفٍ يلوّن الأفق.
البص يشقّ طريقه وسط زحمةٍ كثيفة، حيث السيارات والموتوسيكلات ( البودا بودا ) والحافلات الصغيرة (الماتاتو) تتدافع كالأمواج
في الأفق، ترتفع الأبراج والبنايات الشاهقة، والسيارات تتقاطع كأنها نجومٌ على الأرض،.
دخل البص إلى محطة نيروبي الرئيسية ( ريفر روود) وسط ضجيج لا يشبه سواه: نداءات السائقين، وصوت الموسيقى القادمة من مقهى قريب، ورائحة القهوة الكينية الثقيلة التي تعبق في الهواء، غادرت البص وحملت حقائبي وكنت وقتها أناقش صاحب تاكسي علي مبلغ الرحلة من التاون الي منزلي بعد الاتفاق ركبت بالمقعد الخلفي للسائق ، ومازال صدي
البحر من زنجبار، ورائحة المطر من دار السلام، وصوت الأرض من أروشا— كأنني لم أقطع طريقاً، بل عبرت قارةً من الحكايات
في تلك اللحظة، أدركت أن السفر ليس انتقالاً من مكانٍ إلى آخر، بل عبورٌ في الذات — من بحرٍ إلى جبل، ومن غربةٍ إلى دهشةٍ جديدة ( انتهي).
الجمعة, فبراير 27, 2026
عاجل